أصل الاسم واشتقاقه:
تقع بلدة القلمون على شاطئ البحر المتوسط للجهة الغربية الجنوبية من طرابلس ،أسفل الجبل الذي يقلّ على ذراه من الشرق دير مار يعقوب، و من الجنوب دير البلمند كما يقع دير الناطور للجهة الغربية منها فهي محاطة بهلال صليبي من الجهات الثلاث ، بينما يغسل البحر أقدامها بأمواجه على الساحل الصخري شمالا. و لقد بحث رعيل من الأساتذة الذين زاروها عن مصدر اسمها و من أين اشتقاقه، فيرى بعضهم أنه يعود الى تركيب cale mont حضيض أو أسفل الجبل نظرا لموقعها الطبيعي ؛ أسوة بكلمة البلمند أوbelle mont على أن المربي الكبير الأستاذ فؤاد فرام البستاني يرى أن كلمة القلمون لها علاقة بالقلم و أن مردها الى كلمة kalamus ويراد بها أرباب القلم أو الكتبة و كان ليس فيها الا عالم أو متعلم و ذلك في العهد الروماني أو اليوناني ، و كثيرا ما كان يشحذ همّة طلاب القلمون في دار المعلمين أيام اشرافه عليها لأعادة سالف مجدها من العلم و محاربة الأمية في ربوعها؛ مستندا بذلك الى الرسوم التي كانت بارزة بشكل واضح و جميل في مغارة القديسة مارينا الواقعة على طرف القلمون الشرقي في سفح الجبل. و البعض يرى أن أول من نزل بها طائفة من جبل قلمون في سوريا و أنهم أطلقوا اسم وطنهم الأول على وطنهم الجديد استجلبة لما كان يجيش في صدورهم من حنين ، و يحتج بهجرة الفينيقيين من ساحل الجزيرة العربية الى شاطئ لبنان الذين ما ان استقر لهم المقام على شاطئ البحر الأبيض حتى صيدا إحياء لاسم بلدة لهم هناك ،وكذلك القول في العرب الذين استوطنوا الأندلس فكان لهم مدينة حمص التي هي اليوم اشبيلية و قد جاء ذكرها في رثاء لأبي البقاء الرندي بقوله:
فمـــا بـال بلنسية ما شان مركبة \ وأين شـــــــــاطبة أم أين جيان
و أيـــن قرطبة دار العلــــوم فكم \ مــن عالم قد سما فيها لـه شان
و أيــن حمص و ما تحويه من نزه \ و نــــــهرها العذب فياض و ملآن
قصة القديسة مارينا:
أما حدودها فتتصل من الغرب الجنوبي بالحريشة، ومن الجنوب بأرض قرية دده، ومن الشرق بأرض قرية رأس مسقا ،وتبعد عن طرابلس سبعة كيلومتر، و من التقاليد الدينية في القرى المسيحية المجاورة الاعتقاد أن الأم التي يجف حليب ثديها إن مسحت ثديها بالماء المندّى من صخرة مغارة مارينا درّ حليبه ببركة القديسة مارينا التي نشأت في القلمون وترهبت متنكرة بزي غلام في دير يقع في نواحي قنّوبين و كان لها في تعبدها أيام في القلمون وأيام في قنّوبين حتى أدركها الموت في مغارة هناك تدعى أيضا مارينا ، و رسمت قديسة بعد وفاتها حيث تبينت أنوثتها إذ ذاك ، و على أثر ذلك تقرر في مجمع كنسي قبول المرأة في سلك الرهبنة .إذ كان محظورا عليها هذا بسبب ما يعتورها من العادة الشهرية التي تحول بينها و بين العبادة.
تحرير القلمون من الصليبيين:
يتبين من صدد هذا السياق أن القلمون كانت حتى عهد الحروب الصليبية مسيحية ولها مركز حربي بالنسبة لطرابلس إذ كانت الحامية الصليبية فيها تغير برّا على ضواحي طرابلس مما جعل السلطان المسلم آنذاك يفكر بالإستيلاء عليها و تحويلها إلى مركز حربي إسلامي يرد الغارة و يحمي الضواحي. و هذا ما حصل فعلا فقد استولى على الجانب الشرقي من القلمون حيث توجد عين ماء، فعسكرت القوة هناك و أقام لها القائد مصلى قرب العين فصار اسمها عين الجامع، بينما لبثت القوة الصليبية معسكرة في الجانب الغربي من القرية قرب عين ماء كان الجنود يعربدون حولها إثر الخمور التي يحتسونها حيث أطلقوا عليها اسم عين الخمارة نقيض عين الجامع و هي تحمل هذا الإسم إلى اليوم. و مما كان يقوله المرحوم الأمير أحمد هدى الأيوبي أن قائد الحامية الإسلامية في القلمون اسمه عبد الرحمن و هو ابن السلطان صلاح الدين، و أنه استشهد فيها إثر معركة ضارية جرت برأ و بحرا حيث هجم الأسطول الصليبي بحرا من حصنه في رأس أنفه تعاضده برا قوة عسكرية ؛ فتصدت له الحامية الإسلامية من البحر بزوارقها التي ضُمت الى بعضها البعض وشدت بالحبال أسوة بمعركة ذات الصواري لتكون ميدانا صالحا للسلاح الأبيض ، و من البر بمنجنيق الى جانب السهام المضطرمة نارا ، ثم كان الهجوم الصاعق الذي أسفر عن تحرير القلمون بكامل مساحتها من الصليبيين الذين اندحروا بهزيمة شنعاء الى الحصن القائم على رأس بلدة أنفه و الذي فصل عن البر بخندق يحول بين المسلمين و بين اجتيازهم له و قد استشهد من الحامية الإسلامية ما يربو عن العشرين في البحر فجمعت جثثهم على الشاطىء حيث سميت تلك البقعة ميناء الشهداء ثم دفنت هذه الجثث حول المنطقة الشرقية التي نزل بها المسلمون أولا، بينما الأرض التي جمعت فيها جثث الصليبيين فسميت النواويس(جمع الناووس و هو القبر عند النصارى) الى اليوم.
إهتمام العلماء بالقلمون:
و مما يذكر أن الزاهد السائح و الولي التقي محمد القصيباتي اختار القلمون موطنا له و أنشأ في جهتها الشرقية زاوية يتعبد فيها و يعلم الأهلين أصول الدين والقرآن و حينما ألح عليه أهله بالعودة إليهم أبى قائلا:أنه اختار أرض الشهداء مقرا أخيرا و قد اشترى أرضا أمام الزاوية و جعلها مقبرة له ولموتى المسلمين ، و قد دفن فيها رحمه الله. و كذلك العالم الطرابلسي وهيب البارودي رحمه الله اختار التعليم فيها ، و الإصطياف لاستنشاق نسائم الشهادة و الشهداء من أنحائها ؛؛ و مما يؤكد مكانتها عند أولي العلم سابقا اهتمامهم بتدعيم إسلامها فقد كان في دمشق مدرسة يعمل طلابها حين تخرجهم في نشر التعاليم الإسلامية ؛ وقد خصصت هذه المدرسة للقلمون أحد طلابها و هو الجد الأول لأسرة المشايخ فيها ، وبهمّته قام المسجد الجامع أواخر القرن السابع عشر ثم تبرع المرحوم مصطفى باشا الحدار ببناء مئذنة للمسجد و تسابق المحسنون الى توسيعه ليكون منارة علم و هدى، جزاهم الله خيرا.
شجاعة القلموني ونتائجها:
ولم ينس القلمونيون ما كان لسلفهم في ميدان الفروسية من أثر فالتزموها؛ ففي حين كان غيرهم يفر من الجندية كانوا هم يقدمون عليها برغبة، ليثبتوا في وطيس المعارك أنبل المواقف ؛ ففي الحرب التي دارت بين روسيا القيصرية و الدولة العلية العثمانية كان للمتجندين القلمونيين من البطولة و الفداء و الإستشهاد في المعارك التي دارت رحاها في شوارع العاصمة الروسية من النتائج ما دفع بالدولة العلية الى إصدار فرمانها الملكي (أي المرسوم) بإطلاق اسم سيدة القرى والمزارع على القلمون ، و أن يذيّل توقيع القلموني إذا دعي لشهادة بهذه الجملة : “شهادة سيد شريف قلموني”،(رواية عن المرحوم الحاج زكي مولوي الذي كان قاضيا في العهد العثماني و قد اطلع على الفرمان و طالما تحدث عنه في جلساته)، إثباتا منها لانتسابهم إلى الإمامين النيّرين الحسن والحسين رضوان الله عليهما ، سبطي النبي محمد صلى الله عليه وسلم . كما أجرت لأسر الشهداء راتبا ظل ساري المفعول طيلة الإنتداب الفرنسي وحتى أوائل العهد الإستقلالي.
العلاقة مع الجوار:
ومع إسلامية بلدة القلمون فقد كان للخلق الإسلامي في التعامل مع القرى المجاورة أحدوثة طيبة كان يذكرها رئيس دير البلمند أصائيا ، فيشكرها؛ و كثيرا ما كان ينزل خصيصا لزيارتها و التودد الى أهلها و يتحدث عن ثورة 1860 التي ذهب ضحيتها كثير من اللبنانيين المسيحيين في الجبل، حتى أن بعض أبناء قلحات لم يجسروا على القيام بقطاف ثمر زيتونهم في الحريشة ،فكان جارهم القلموني في العقار إما أن يقطفه لهم و يذهب به إليهم في قرية قلحات أو أن يتفقدهم في قريتهم فإذا علم أن السبب هو الخوف عاتبهم وقال لهم: تمد إلى أحد منكم يد بأذى ونحن أحياء. و هكذا كان الموقف مع أنفه وكان الطيب الذكر جبران مكاري كثيرا ما يردد أيضا هذه الأحاديث حينما ينزل إلينا زائرا . وليس أدلّ على حسن العلاقة المتبادلة منذ عهد بعيد بين القلمون و ما جاورها من قرى من حادثة يوسف كرم الزعيم الزغرتاوي حينما غضبت عليه الدولة العثمانية ، فلم يجد خيرا من هذه البلدة المسلمة يعتصم بها ، مما سبب لأسرة المشايخ فيها أن صبت الدولة على الأسرة جامّ غضبها ، ولكن ذلك لم يغير من المودة و حسن العلاقة مع الجوار شيئا ، بل جعل القلمونيين حين عمت المجاعة و انتشرت الأمراض الوبائية وأطلق الأتراك على هجر الأهلين لأوطانهم اسم “سفربرلك” أن كانوا يخصصون قسما من إعاشتهم لأهل الجوار، بهذا طالما تحدث الطاعنون بالسن منهم اعترافا بالجميل و حسن العلاقة.
مهن أهل القلمون:
هذه البلدة التي كانت قرية تعج مزرعتها بشجر التوت ، تحولت بهمة السكان الى مزرعة من الزيتون لا تقل مساحتها عن ثلاثمائة فدان ، إلى سليخ يزرع من الحبوب على اختلافها ما بين قمح و شعير و ذرة وحمص ،إلى اعتناء خاص بالليمون الحامض منه والزفير ، كما اعتنت بالملاحات حيث حول الأهلون بصبرهم و جلدهم صخر الشاطئ إلى مورد عوّلت عليه القلمون زمنا ودافعت عنه حينا حتى هجرته أخيرا حينما أهملت الدولة صيانته ،وكانت مهنة الأكثرية من سكانها تقليم الأشجار والزراعة والحراثة التي كانت تؤدى بواسطة السكة يجرها الثور. أما الصناعة فتقوم على تقطير ماء الزهر والورد، ومربى الزفير؛ إلى أن كانت الخمسينات حيث قام في ضواحيها معمل لتكرير الملح، يشرف عليه آل قبيطر، ثم مصبغة لهم أيضا؛ تلتها مصبغة أخرى يملكها عبد الرحمن دنكر، فمعصرة لكل منهما لتكرير الزيت وعصر الزيتون.
الأوضاع الإقتصادية:
إن علاقة أبناء القلمون مع بعضهم، واشتراكهم وتعاونهم في السراء والضراء لم يجعل للفقر المدقع سبيلا، نعم هناك تفاوت في الملكية النقدية والعقارية ؛ كما هناك نفوس خيرة ونفوس شحيحة ؛ ولكن المساعدات السرية كانت تبلسم الجراح وترفع المستوى، كما أن النفس الأبية كانت تحول دون معرفة المحتاج إلا بعد مشقة من البحث. من ذلك أحد الملاك المزارعين أدى فريضة الصبح وذهب إلى بيدره المملؤ قمحا وحينما دنا أحس بحركة فأطل وإذا بامرأة تحثو بيديها حثوات من القمح لم يتبينها بسبب الظلمة وكأنها شعرت هي به فولت مدبرة فلحق بها حتى عرف منزلها وأنها أرملة أم أولاد، فعاد باكيا مؤنبا نفسه على عدم تفقدها ثم حمل على ظهره كيسا من القمح وجاء به إليها كما نقدها شيئا من الدراهم واعتذر عن تقصيره.
تطور العلم في القلمون:
أما القلمون حاليا ففيها من المعلمين والموظفين ما يناهز الألف؛ وذلك بفضل النهضة العلمية فيها بحيث تجد الأب يعمل ويبذل مضحيا في سبيل بنيه وبناته لتعليمهم ما وجد فيهم الرغبة إلى ذلك؛ وبعد أن كانت المدرسة في السابعة عبارة عن غرفة تضم بنين وبنات لا يزيد عددهم عن ثلاثين؛ أصبح فيها للبنات مدرسة تكميلية منذ 1953 ومدرسة للصبيان تكميلية منذ 1950 فيهما ألف طالب وطالبة. وكان الإقبال على العلم منقطع النظير بحيث كان المطران العبد يقول: الذي يلفت النظر في ناشئة القلمون أن أحدهم وهو يمشي إلى جانب رفيقه لا يتلهى بالحديث إليه وإنما بحديثه إلى كتابه؛ هذه البلدة لا تكافأ بما تقدمه للبنان إلا برفع صروح العلم فيها.وكان أن حادث فخامة الرئيس سليمان الذي رحب بالفكرة فمنحها الثانوية التي أصبحت تعطي أكلها منذ 1973 وكذلك مشروع تجمع المدارس الذي ينتظر تنفيذه ضمن نطاقها قريبا إن شاء الله. كان العلم فيها يتناول الخط ومبادئ القراءة وحفظ القرآن ويقوم بذلك نفر لا يتقاضى أجرا أمثال الشيخ أحمد حفيد الشيخ علي منى الله، ثم ابنه الشيخ محمد كمال، والشيخ أحمد صهيون يدرس القرآن وأصول الخط؛ إلى أن تبنت الدولة العثمانية ذلك فكان يقوم من قبلها بالتعليم الشيخ وهيب البارودي، ثم تلاه الشيخ عبد اللطيف رحيم فالشيخ أكرم الخطيب الذي ظل حتى مطلع الثلاثينات ليخلفه إذ ذاك الأستاذ محمد سعد الله الكاشف من طرابلس؛ وأول من نال الشهادة الابتدائية عهد الإنتداب هو الأستاذ حسن فلو وكان لهذا النجاح أثره الحسن خصوصا حينما أجرت القلمون حفلة ابتهاج بنجاحه خلال عام 1936 وتبعه بالنجاح الأستاذ عبد الرحمن عبيد ثم العقيد أحمد زكا.
وامتد عهد النهضة العلمية إلى الأنثى، فبعد أن كان الأثر العلمي الذي تلم به عبارة عن مجرد الكتابة والقراءة فقد أصبحت منذ فجر الاستقلال تتخطى هذه العتبة إلى الشهادة الابتدائية فإلى الشهادة التكميلية في الخمسينات، وكان أول رعيل منهن تقدم إلى الشهادة الابتدائية: شهيرة عكرة، فائقة فلو، فاطمة سوقية، سميرة حكم، وغيرهن لتنخرط القلمونية فيما بعد بسلك التعليم أسوة بالقلموني، وتسير في درجات العلم إلى التخصص جنبا إلى جنب مع ابن بلدتها فتخصصت بالطب وغيره من علوم الكيمياء والفيزياء لتخصصه؛ ملتزمة الصبغة التعاونية والتنافس التي التزمتها أسلافها أيام كان مدار النشاط في الحقل والبناء وقد سبب هذا النشاط العلمي وما يدره من كسب إلى هجر زراعة الحبوب والحراثة في السهل والسفح ليخلفها حرث العقول وزرعها بالعلوم والفضائل.
قيام الجمعيات و الكشافة وأثر ذلك على الصعيد المحلي:
إن ما يتميز به القلموني سرعة تطوره وعدم التزامه بالتريث في الإنشاء والابتكار، فهو إذ يقتدي، يخطو كي يبرز على سابقه، وهذا من شأنه أن يعقبه فتور أو تحول، فهو حينما يرى في طرابلس أو القرى المجاورة قيام هيئة أو جمعية تسعى لإنشاء ناد أومكتبة أو مدرسة لا يلبث أن يسلك المنهج نفسه في قريته ففي سنة 1946 قامت جمعية أصدقاء المدرسة في القلمون وبصفة رسمية، المؤلفة من السادة محمد حسن الأبيض رئيسا، محمد عبد الرحمن المحمد أمين صندوق، الحاج مصطفى الطواف جابيا، توفيق نور نائب رئيس وحسين بكري الحكم أمين سر، فتمكنت من إنشاء مدرسة رسمية مؤلفة من سبعة عشر غرفة؛ كانت مجلية في دورات الامتحانات الرسمية ردحا من الزمن ولا تزال رسائل وزارة التربية شاهدة على ذلك، وخلال عام 1949 قامت جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية في القلمون يرؤسها مختار القلمون في ذلك الوقت عبد الرحيم المحمد حيث نهدت إلى إنشاء مدرسة للبنات مع مطلع عام 1951 على مقبرة القصيباتي، لتغدو خلال الستينات مؤلفة من ثمانية عشر غرفة معلماتها وإدارتها من متخرجاتها كزميلتها مدرسة الصبيان؛ وحفلت القلمون خلال نشاط المكارم بإحياء مهمة مصلى عين الجامع بالتعليم المجاني للطلاب خلال الصيف وبتعليم الأميين طوال أيام السنة ليلا كما بنت غرفة إزاء المسجد تكون نواة مكتبة عامّة يعلوها قاعة لإلقاء المحاضرات التربوية والتوجيه الديني إلى تأليف فوج المنار للكشافة الذي أحدث دويا عام 1953 في ميدان الرياضة والتمثيل التاريخي مما جعل محافظ الشمال الراحل نعيم العياش يجتمع بالعميد مهنئا وكذلك ممثل الدولة الجزائرية المرحوم محمد خضر حين مروره بالقلمون الذي نزل خصيصا لشكر عميد الفوج على استقباله الرائع وكلمة الترحيب؛ وأعطت هذه المشاريع أطيب الثمار لسنوات خلت لكن الفتور تسرب إليها كما تسرب إلى جمعية أصدقاء المدرسة فذوت كل منهما ثم تلاشت لتبقى صروح العلم في القلمون شامخة برعاية الدولة اللبنانية تؤتي أكلها كل حين نجاحا مستمرا.
دخول الماء والكهرباء إلى البلدة:
ولم تبخل الدولة على هذه البلدة فقد حبتها بالكهرباء عند أول وفد راجعا بذلك سنة 1956 ثم بالماء سنة 1962 إثر مظاهرة قامت بها لمحافظة الشمال أعقبها وفد لرئاسة الوزارة فلم تخيب الرجاء؛ مما شوق أرباب الحرف إلى تعاطي حرفهم بها كزخارف الأدوات النحاسية ونجارة الخشب المزركشة حتى غدت سوقا رائجا لهذه الصناعات يزورها اليوم السواح وطلاب الزينة، ومما لا ينسى في هذه الآونة نشاط فئة من الأساتذة عمدوا بروح من الشغف العلمي إلى إنشاء روضة خاصة تتدرج إلى مصاف الكلية أطلقت عليها اسم روضة الرياحين تنشئ طلابها تنشئة دينية وعلمية وهي عامدة إلى القيام بمشروع مدرسة المنار إحياء لذكرى صاحب مجلة المنار الإسلامية الإمام المجاهد السيد محمد رشيد رضا الحسيني؛ مما يؤكد أن الحيوية الإسلامية وروح التدين، رغم وجود الحزبية على اختلافها، ما زال الأقوى والأكثر فعالية وإنتاجا خصوصا وأن رابطة من ناشئتها يقومون كجماعة إسلامية بالتوعية الدينية ويعملون على توطيد دعائم الأخوة بين أبناء البلدة.
بعض الصفات الإجتماعية:
ومما ابتلى به القلموني حب الظهور، فحينما كان الفوتوغراف يجتاز بأغانيه ساحة الوطن كانت القلمون الأسرع إلى اقتنائه عام 1929 وهكذا كان موقفها من الراديو خلال 1938 إذ كانت المقاهي بها تغص بزوارها لسماع القرآن الكريم ثم الأخبار مع كثير من الدهشة والغرابة منه وهو متصل ببطارية كهربائية يحمل إليها أنباء العالم وتطور الحرب العالمية الثانية – روح التدين ما زال هو الأقوى رغم ازدحام الحزبية فيها، وهذا من نعم الله عليها لأنه يبعث فيها حب السلام والدليل أنه رغم اختلاف العقائد الحزبية التي تعج فيها، فرابطة المودة والصداقة والألفة هي السائدة وهذا بفضل الروح الإسلامية المتغلغلة في النفوس فلا شجار ولا خصام يفضي إلى مد الأيدي، حتى أن المحاكم المدنية والشرعية لم تحفل منذ عهد بعيد بقضايا خلاف أو طلاق حتى عرفت القلمون بذلك؛ وفي الثورة المشؤومة الأخيرة كان ظهور السلاح في القلمون يعتبر عند جيرانها كظاهرة غريبة عنها نظرا لحياة السلم والسلام التي تغمرها قديما وحديثا؛ لقد تضاعف سكانها كما تضاعف دورها وتخترقها الطريق الدولية منذ مطلع عهد الانتداب الإفرنسي وسيشملها الأتوستراد بأهمية جغرافية أوسع؛ وكفاها فخرا أنها قدمت للعالمين المسيحي والإسلامي في القرن الحادي عشر والقرن العشرين شخصين خلد اسمهما تاريخ الإنسانية: القديسة مارينا والعالم السيد محمد رشيد رضا الحسيني.
السكن و اللباس و التنقل:
في الختام حينما أطل عهد الانتداب كان كل قلموني مع أسرته يملك دارا يسكنها قد تكون مؤلفة من غرفة وقد تكون دارا مؤلفة من عدة غرف وتتراوح الملكية بينهم في المنازل والأراضي سعة وضيقا إلا أنه لم يكن فيها من لا يملك. وأقدم منزل فيها اليوم هو الدار الملاصقة للمسجد ويعود تاريخ إنشائه إلى 1232 هجرية و1817 ميلادية وهي التي نزلها فقيد لبنان يوسف كرم كما مر معنا سابقا؛ وكما تطورت المنازل واتسعت رقعتها وسمت في الجو، تطور اللباس بدءا مع نهاية الحرب العالمية الثانية، فبعد أن كان القلموني يلبس الطربوش والصدرية والسروال والمرأة تلف رأسها بالخمار وترتدي التنورة فلا يرى منها إلا وجهها وكفاها وقدماها، فقد انسلخ ذلك تدريجيا حتى غدا الغطاء للرأس لا تلتزم به سوى طائفة لا تتعدى ثلث فتيات القلمون كما أن السروال والطربوش فقد انتسخا عند الرجال والشباب تمشيا مع روح التقليد المستوردة، والتنقّل الذي كان في الماضي على الدابّة أو القدمين أصبح منذ 1930 في السيارة عند البعض؛ ثم صارت للجميع عمالا وطلابا حتى إذا انتعشت ماديا بحكم اتساع نطاق الوظيفة والتجارة امتلك جل موظفيها سيارات خاصة حتى غصت بها طرقها الداخلية والخير معقود إلى ذلك بحسن التصرف، ولله في خلقه شؤون وبالشكر تدوم النعم …
_______________________________________
*بقلم الشيخ عبد الرحيم آل محمد رحمة الله عليه


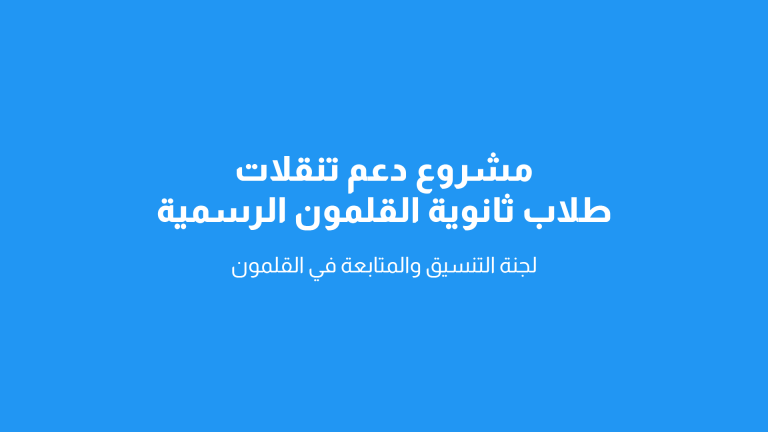

1 thought on “بلدة القلمون”